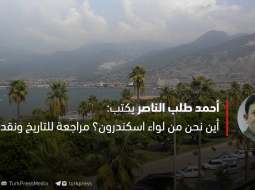أحمد طلب الناصر- خاص ترك برس
لا شك بأن مرحلة حكم السلطنة العثمانية هي أطول المراحل التاريخية التي خضعت من خلالها منطقة المشرق العربي، في الشام والعراق والحجاز، لحكم مركزي صلب، منذ بزوغ أنظمة الدول والإمبراطوريات الكبرى في العالمين القديم والحديث.
يضاف إلى ذلك أن الدولة العثمانية تربطها بشعوب المنطقة، قبيل وخلال امتدادها، صلة الدين الإسلامي، السنّي، الذي لم يكن يخالفهم فيه في تلك المرحلة سوى آل صفيّ الدين (الصفويين) في إيران الذين أرغموا شعبهم على اعتناق مذهب "التشيّع" ومن ثم تحوير وتحويل ذلك المذهب من توجّهه الفكري العاطفي، بواسطة القمع والسلاح، إلى تيّار ديني سياسي من خلال إدخال مفاهيم ومعتقدات فارسية شعبوية وعصبوية وممارسات بعيدة كل البعد عن روح الإسلام، والسبب في ذلك يعود لتخوّفهم من تقبّل الشعب الإيراني، ذو الغالبية "السنيّة" آنذاك، لحكم الدولة العثمانية التي فتحت أبواب أوروبا وشكّلت بداية إمبراطورية إسلامية واسعة امتدت لنحو أربعة قرون ونصف من الزمان بعد فتح القسطنطينية، أضف إلى ذلك تجييشهم سياسياً ودينياً وقومياً ضد العثمانيين الأتراك. ومنذ تلك اللحظة والعالم الإسلامي، الذي كان متمثلاً حينذاك بدولة آل عثمان، وهو يعاني من طعنات وانتكاسات عانى منها العثمانيون والمجتمعات الإسلامية بشكل متكرر كلما فكّروا بالتوجه لفتح الغرب قديماً، أو الحفاظ على وحدة العالم الإسلامي في المرحلة المعاصرة.
صراحةً، ليس موضوع إيران وتشيّعها السياسي وامتداده لاحقاً ليشمل معظم شيعة المشرق العربي والعالم ما أنا بصدده الآن، إلا أن ما دعاني لذكر تلك الوقائع التاريخية بصورة سريعة هو انعكاساتها الكارثية على ما مر به المشرق لاحقاً، ابتداءً من تحولات القرنين التاسع عشر والعشرين، واستمراراً لهذه اللحظة.
فعلى غرار الدولة الدينية السياسية (الثيوقراطية) المتمثلة بالإسلام "الشيعي" والقومية الفارسية، التي كان مركزها إيران، المستولية آنذاك على العتبات المقدسة لمركز العالم الشيعي "العراق" لولا تحريره على يد السلطان سليمان القانوني 1534م، ظهرت في الجزيرة العربية، أواسط القرن الثامن عشر الميلادي، بوادر دولة ثيوقراطية أخرى متمثلة بالإسلام "السنّي"، قومية قبلية (آل سعود) تبنّت أفكار محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية، كما هو مفترض، لتمتد في نجد وعسير والإحساء والحجاز وتسيطر على أهم بقعتين في العالم الإسلامي السنّي "الحرمين الشريفين" لتتحكم بالمسلمين السنّة، سياسياً ودينياً، ما دفع السلطان محمود الثاني إلى تكليف واليه على مصر "محمد علي باشا" بالقضاء على الدولة السعودية الأولى، وتمّ ذلك على يد ابنه إبراهيم سنة 1818م.
لنعد إلى الوراء، قبل ذلك بنحو 3 قرون تقريباً. فبعد هزيمة الصفويين في معركة جالديران 1514، وبعد إتمام سيطرة السلطان سليم الأول العثماني على الشام 1516 ثم على مصر 1516م وإنهاء سلطة المماليك، قام آنذاك شريف مكة "بركات بن محمد" بتسليم مفاتيح الحرمين للسلطان سليم بدون صدام أو قتال، فأقرّه سليم أميراً على الحجاز ومنحه الراية والختم العثماني.
ظل العثمانيون محافظين على إبقاء الأشراف أمراء على الحجاز منذ بركات وصولاً إلى سيطرة الدولة السعودية الأولى ثم بعدها، إلى أن وصلوا إلى الشريف حسين، الذي تحالف مع الإنكليز ضد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، ثم قسّم دول المشرق العربي بين أبنائه، وهرب بعدها وتنازل لآل سعود، في دولتهم الثانية، عن الحرمين الشريفين، علماً بأن آل سعود أيضاً تسلّموا البلاد بواسطة الإنكليز!
طعنة الشريف حسين للعثمانيين صارت تسمّيها كتب تاريخنا العربي المعاصر "الثورة العربية الكبرى" لإضفاء الصفة القومية "العروبية" واستخدامها ضد الأتراك لا سيما وأن الرابط الإسلامي "السنّي" كان يشكّل إحراجاً واضحاً لدى حسين وأتباعه وكذلك البريطانيين الذين عملوا على زرع وإثارة هذه النزعة القومية مستغلين صعود حزب "الاتحاد والترقي" القومي في تركيا.
"الثورة العربية" إذن كانت بقيادة الإنكليز! وقدّمت لهم وللفرنسيين أيضاً، خلال أقل من سنتين، استعمار المشرق العربي، وأهدت "ثالث الحرمين" وكامل فلسطين لليهود كي يؤسسوا فيها "أرض ميعادهم" المزعومة، تلك الأرض التي جاهد عبد الحميد للحفاظ على كل شبر فيها رافضاً كل العروض السخيّة التي قدّمها له الصهاينة اليهود.
ومنذ ذلك الحين ونحن نتجرّع ما خطّته لنا أنظمة دولنا العربية في كتب التاريخ تلك، والتي هي أيضاً-الأنظمة- من مخلّفات الاستعمارين البريطاني والفرنسي. فصرنا نطلق على الحكم والتوسع العثماني تسمية "الاحتلال العثماني" رغم أن المماليك قبلهم وهم ليسوا من العرب لم نطلق عليهم لقب محتلين. وكذلك أصبحنا نعلّل أسباب انتكاساتنا اللاحقة بـ "التخلّف العلمي والسياسي والحضاري والصحّي بسبب الاحتلال العثماني!" وكأن أنظمتنا العربية وفّرت لنا لاحقاً حرية التفكير والإبداع ولم نفلح! وتأخرَنا بالنهضة الصناعية بسبب "سرقة السلطان سليم لكل الصناعيين والحرفيين من الشام ومصر ونقلهم إلى الأستانة" وكأن السوري أو المصري في ذلك الوقت كان مخترع مولّد الكهرباء ولم يكن مجرّد فنّان موزاييك ويتقن الحفر على الخشب وصناعة "الأرابيسك" أو مطرّز، ينتشر مثلهم الآلاف ولم يغيبوا عن حارات دمشق والقاهرة حتى الساعة. أما تردّي مفاهيمنا الدينية وعاداتنا الاجتماعية فيعود إلى "دخول عادات وأعراف غريبة وسيئة إلى الدين من خلال العثمانيين" وصراحةً لا أجد لدى الأتراك شيء غريب أو مبالغ به خلال تواجدي في إسطنبول، أما تزيين القبور ومقامات الأئمة فهي تشبه قبر جدّي في مدينة ديرالزور السورية! وبخصوص ما يتعلّق بالفكر والطرق "الصوفية" فمعظمنا يعلم أن أصول أصحابها الأوائل من الشام والعراق، كالجيلاني والرفاعي والنقشبندي والراوي وغيرهم. ثم أننا نعلم جميعاً بأن المذاهب المتشددة، كالوهابية مثلاً، لم يكن لمعتنقيها ومراكزها أي انتشار في الشام أو العراق عقب نهاية المرحلة العثمانية.
الخلاصة، وبعد كل ما واجهه العثمانيون من مؤامرات استهدفت كيانهم في الماضي، وأقلام لوّثت تاريخهم في الحاضر، تكون الغاية المرجوة لبريطانيا وقوى الغرب قد تحقّقت في التخلّص من سلطة العثمانيين، كدولة ذات نظام سياسي مركزي حديث، تشرف على حماية الأماكن المقدّسة دون احتكارها أو المسّ بسيادتها، وتحافظ على وحدة الولايات العربية والإسلامية من خلالها في مواجهة التحالفات الدولية ضدها، وإيران وأطماعها على وجه الخصوص، واستبدال الدولة العثمانية بكيان قبلي ذو نظام وسلطة دينية سياسية "متطرّفة" وتصديره للعالم بأنه الممثل الرئيس للإسلام "السنّي" في المنطقة والعالم، وتصويره أيضاً بأنه السدّ المنيع ضد القوى الدينية الإسلامية السياسية الشيعية "المتطرفة" الأخرى، إيران. علماً بأن السعودية منذ قيام دولتها لم تتدخل لمساعدة أي دولة عربية أو إسلامية "سنيّة" تسيطر عليها إيران الأضعف منها اقتصاداً وعلاقات دبلوماسية ومركزاً دينياً عربياً وعالمياً، بل على العكس تماماً، فإن سياستها وإعلامها الحاليّين مثلاً يدعمان الحشد الشعبي الشيعي المدعوم إيرانياً في العراق، أما حربها في اليمن فهي عبارة عن حرب تدمير للقضاء على ما تبقّى من ثورة اليمن، وتقسيمه، ومن ثم إعادة تصنيع علي عبدالله صالح، العائد إلى اليمن من الأراضي السعودية بعد علاجه، والحوثيين، لحكمها من خلال مبادرات لاحقة. وكذلك الأمر بالنسبة لدعمها انقلاب العسكر المتمثّل بالسيسي على الشرعية في مصر، ودعم حفتر وميليشياته في ليبيا، وأخيراً وليس آخراً دعم الانفصاليين من الكورد في الشمال والشرق السوري، ومغازلة النظام السوري في الخفاء. ولن أدخل في أزمتها الأخيرة مع جارتها قطر، فهذا له شأن آخر يطول الحديث عنه، وجاء على ذكره الكثيرون.
إذن، من حق التاريخ علينا أن نعيد صياغته بالصورة الحقيقية أو قراءته على الأقل ضمن سياقه الديني والسياسي والاجتماعي الصحيح لنتمكّن، ولو جزئياً، من العودة إلى سكّة الصواب بعد عقود طويلة من التلوّث والتخبّط في مفاهيم خرّبت ما خرّبت من أدمغتنا نتيجة تشبّع مجتمعاتنا في المشرق العربي بنظريات القومية والشعوبية، والدينية، والطائفية السياسية، بحجة "الوطنية والمواطنة"، وماذا خلّفت في النهاية؟ مجرد شعوب عانت من القمع والتشويه هاجرت أوطانها عند انطلاق أول شرارة لنهضتها، ملتجئة صوب البلاد التي شاركتها جزءاً عظيماً من تاريخها الحقيقي قبل طمسه من قبل أنظمتها. والسوريون اللاجئون إلى تركيا خير دليل، ولعلّه يكون بداية جديدة لإعادة التكوين.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس