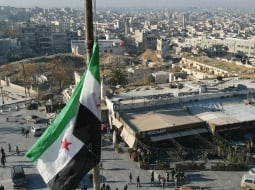ياسين ابو عمر - خاص ترك برس
مضت عقود على مصطلح راجَ في الإعلام المقروء والمسموع لسنواتٍ، ويزعمون أن ثماره ما زالت حتى اليوم تتقطّف هنا وهناك، وهو (الأفغان العرب).
وهو باختصار يحكي أحوال شبابٍ من العرب بمختلف دولهم هبّوا لنجدة المسلمين الأفغان بوازعٍ شخصيٍّ، أو بتحريكٍ من حكوماتٍ كانت مساندةً للأفغان في حربهم على السوفييت.
كان يجمعهم أنهم خرجوا لأرضٍ غير أرضهم، وتعايشوا مع شعب غير أهليهم الذين وُلدوا بينهم، وكانت تفرّق بينهم انتماءات حزبية أو فكرية، لكن ما كان يجمعهم أقوى وأكبر مما كان يفرّق. وتنازعتهم الأرض الجديدة فوق اختلافاتهم الشخصية فوقعَ افتراق جديد لهم، فهؤلاء ذهبوا مع فريق من أهل البلد وأولئك مع الفريق الآخر.
لاشك أنهم وجدوا أرضاً أرحم بهم من أرضهم التي خرجوا من رَحِـمها، وأنهم استساغوا ماء أفغانستان بعد أن غصّوا بماء بلدانهم وغصّت بهم حكوماتهم فيما بعد، وربما من قبل ومن بعد.
وقد كان الأفغان العرب يسمّون أنفسهم: (المجاهدون الأنصار).
لا تغيب عنا صورة مَن سُمي (أول الأفغان العرب) بالكوفية الأفغانية، أعني الشيخ عبد الله عزام رحمه الله، وقد يغيب ما كان له من خلاف مع الذين خرجوا أكثر عما يعرفه ويألفه المجتمع الأفغاني فكراً وفقهاً ومنهجاً. ولباسُ عزّامٍ وغيرُه يَشِي بفقه الإخوة حينها، فهم آثروا موافقة أهل البلد حتى في المظهر، وكانت لهم مواقف وأخبار عن موافقات لهم فيما فيه سعة من الفقه كذلك.
وبعد أن وضعت الحرب ضد السوفييت أوزارها، وفكّر بعض الأفغان العرب بإجابة داعي الشوق والحنين للوطن لم يشعروا أنهم باتوا غير مرحَّب بهم في أوطانهم وتثاقلت بهم دولهم والدول التي دعمتهم، فداخوا ومنهم مَن وقع في شرَك الغلو فصار قنبلة موقوتة تنفجر هنا وهناك، ومنهم مَن مالَ إلى فئة ممن وافقه خطّها الفكري أو السياسي في بلد المهجر، ومنهم مَن ترك الجهاد وساحات القتال وصار مواطناً من مواطني البلد الذي هرب إليه يوماً.
وعند النظر في قضية العرب الذين تقاطروا على تركيا خلال العقد الأخير تُلقي تجربة الأفغان العرب بظلالها علينا.
ومع ما بين التجربتَين من الاختلافات إلا أن بينهما قواسمَ تفرض علينا أن نستفيد من دروس الأفغان العرب؛ فمَن صاروا أفغاناً عرباً في ثمانينيات القرن العشرين كانوا في الأصل سعوديين وكويتيين ومصريين وعراقيين وسوريين ومغاربة، ضاقت بهم بلدانهم فبحثوا عن بلد يستقبلهم يجمعهم معه جامع أو جوامع، فوجدوا أفغانستان، ووجدوا فيها ساحةً يطبّقون أحلاماً كانت محرَّمةً عليهم في بلدانهم حتى في نومهم من الجهاد والدعوة وإغاثة الملهوف وإطعام الجياع.
ولم تكن أفغانستان الجنة ولا نزلاؤها من أهل الجنة المبرَّؤون المعصومون، فوقع ما يُحمد منهم ويُنكر، ووقع عليهم ما يُنكر من أهلها، دون نسيان ما قُدِّم لهم مقابل صمودهم معهم، بل دفعت طالبان لعدم تخليها عن واحد من الأفغان العرب حكمها ودولتها ثمناً. مع أن بعضهم قَتل وبعضهم الآخر قُتل في حسابات داخلية ودولية كانوا وقوداً لها.
ولأن الدِّين الإسلامي يجمع الأفغان مع الأفغان العرب، فيجتمعون في بيوت الله ذاتها، ويتبادلون التحيات والأحزان والأفراح في المناسبات عينها، ولأن الدم الجاري في العروق فيه هموم وآلام وآمال واحدة؛ لم يذكروا اللغة والشكل وبطاقة الهوية فوارق جوهرية تحول بينهم وبين إخوتهم الوافدين إليهم، فما جاؤوهم إلا نصرةً لهم أولاً ثم هرباً من ظلم حكّامهم ثانياً، فتزاوجوا وأصهروا إلى الأفغان وتقاربوا.
أظن أنه لم يعد صعباً الآن على أحد استنتاج وجوه التلاقي بين التجربتَين، وضرورة الاستفادة من تجربة مضت بأكثر أهلها في تجربة قد تكون في أولها وإن كانت مضت خمس سنوات هي بعُمر الثورات مقدّمة وإن كانت لمن عاشها قروناً متطاولة.
فمَن هربوا إلى تركيا من اليمن والعراق ومصر وفلسطين وسوريا ودول الاتحاد السوفيتي سابقاً لا يبعدون عمن دخلوا أفغانستان من الأفغان العرب؛ فهذا جاء فأكملَ دراستَه، وثانٍ نقلَ مَعاملَه فجدّد إنتاجَه في تركيا، وثالث تطوّع في إغاثة الناس وطبابتهم وتعليمهم، ورابع هرب ليؤمّن على نفسه وأهله بعد أن لفظتْه دولتُه وحاكمُها. والأتراك اليوم يطلقون على المهاجرين المسلمين - لاسيما من السوريين -: (الأنصار).
وهذا يؤكّد أن مَن لجأ إلى تركيا لجأ إليها لرابطة الدِّين والهمّ، لرابطة الخلافة العثمانية التي جمعتهم قروناً، وإن كانت فرّقت بينهم السياسة لعقود خلت، وصار كلٌّ من الطرفَين ينظر إلى الطرف الآخر من طرْفِ غدرٍ وطعنٍ، فلما وقعت المأساة تناسَوا كل ذلك وتعالَوا فوق الجراح الطارئة ليعيشوا المجد الذي نعموا به قروناً في ظلال خلافة عثمانية. لكن فقه الأفغان العرب وفهمهم أيام تجربتهم يبدو أنه أكبر من فقه (العثمانيين العرب) اليوم، فيومَ لبسَ عزّام والأنصار معه اللباس الأفغاني لم يلبسوه لتوفره في الأسواق فحسب، بل ليكون ما يجمعهم مع أهل البلد أكثر مما يفرقهم عنهم، وما كان فيه مندوحة من أبواب الفقه وافقوا فيه أهل البلد المتعصبين للحنفية؛ فليس من الفقه ولا الفهم مخالفة أهل البلد فيما لا حرمة فيه، ومن الفقه والحكمة موافقتهم فيما فيه سعة حتى في اللباس. والعثمانيون العرب اليوم يتاجرون ويتجولون ويعملون في رحاب تركيا، فموفَّق ومتعثِّر، ومِن سالكٍ أبوابَ الحلال ومتسرّبٍ في دهاليز الحيَل والحرام ليكسب؛ ولكن الحلال يبقى، وإن ذهب فيذهب ويبقى أهله، وأما الحرام فيذهب وأهله!!
وأمّا ما يكون من كلا الجانبَين من أخطاء فينبغي أن نستذكر فيها ما وقع بين الصحابة بعد أن آخَى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنادَوا بنداءات الجاهلية، فزجرهم النبيّ الكريم وبيّن لهم أنها جاهلية، فما أصعبَ جاهليات القرن الواحد والعشرين، فما إن يقع التنادي في أرض الواقعة حتى يتردد صداها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر (هاشتاغ) أو (وسم)، والله المستعان، وما كل المهاجرين كسعد بن عبادة ولا كل الأنصار كأبي بكر وعمر. المهم ألا ننساق وراء دعوات جاهلية تُعمي عن الحق، وأن نلتزم آداب الجوار والإقامة، فمَن ساءَه شيءٌ فأرض الله واسعة
وفي الأرض منأىً للكريم عن الأذى ........ وفيها لمن خاف القِلَى متعزَّل
وفوق ما كان للأفغان العرب فالدولة التركية (خليفة العثمانيين) تمنح مَن تراه يزيد في قوّتها الفكرية أو الاقتصادية هويّتها، فلا يبقى شيء يميز مَن وُلد في أرضها عنه.
غير متناسين في هذا أن الدولة التركية اليوم لن تدفع البلد بأهله كما دفع غيرها فداء لشخص؛ فالبلد أغلى والأمّة مقدَّمة على الفرد أياً يكن.
وإن طالبنا الأتراك أن يكونوا (عثمانيين) كالفاتح وسليمان القانوني فلا نكن من العرب الذين طعنوهم في الجزيرة ومصر يوماً، بل ممن ضحّوا معهم في جناق قلعة وأوربا؛ فهويتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله قبل كل البطاقات التي في جيوبنا.
ولن يقتنع الأتراك أن هجرات هؤلاء العثمانيين ليست كهجرة اليهود لفلسطين حتى يروا ممن هاجر إليهم أمثال عبد الرحمن بن عوف (دلَّني على السُّوق)، وستيف جوبز الجندلي الحمصي، أو عمدة لندن البريطاني الباكستاني، أو رؤساء أمريكا اللاتينية الشاميين؛ فالهجرات مذ هجرة النبي للمدينة إثراء ونهضة ودماء جديدة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مواضيع أخرى للكاتب
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس