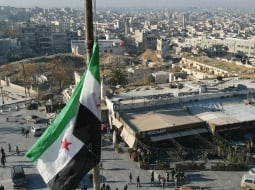محمد إلهامي - تركيا بوست
كلما أطل علينا شهر ديسمبر حمل معه ذكرى رحيل الأستاذ العملاق والمفكر الكبير “محمد جلال كشك”، الذي توفي (5 ديسمبر 1993م).
أثناء مناظرة مع العلماني نصر أبو زيد عن الكتاب الفضيحة لهذا الأخير “الإمام الشافعي وتأسيس الأيدولوجية الوسطية”، وكانت أظهر فضائحه أنه جعل الشافعي عميلا لبني أمية وهو الذي وُلِد بعد غروب دولتهم بعشرين سنة! وكان جلال كشك قد تعرّض لهذا الكتاب بفصل في غاية القوة ضمن كتابه “قراءة في فكر التبعية” والذي كان آخر كتبه ونُشِر بعد وفاته رحمه الله.
لم يمت جلال بالسرطان الذي كان قد أصابه قبل وفاته بسنين وحدّد له الأطباء في أمريكا ستة أشهر، ولكنه عاش بعدها سنين ليموت بأزمة قلبية في هذه المناظرة، فكانت ميتة شرف وحسن ختام لرجل ظل يكافح أعداء الأمة وينازلهم ويسحقهم ويكشف سوآتهم، وأحسب أنه لولا جلال كشك ما استطاع أحد أن يخدش مكانة محمد حسنين هيكل، رأس الثقافة والسياسة في عصره والذي ما يزال يحظى بتقدير كبير في دائرة الإعلام العربي لا لشيء إلا لأنه من زعماء العصابة الإعلامية العربية ربيبة الاحتلال وخادمته.
من يقرأ في التاريخ الحديث يعرف أن جلال كشك يكاد يكون الوحيد الذي تصدّى لهيكل بكل عنف، وتحدّاه بكل قسوة، وصلت إلى أن ينابذه علنا ويستفزه أن يذهب به إلى المحكمة، وهيكل لم يحاول أن يرد أبدا، لكنه كان دائما يطلق صبيانه على جلال كشك ويدعمهم معنويا وقضائيا لينالوا منه، ولكن: ماذا يأخذ الكلاب من بين يدي الأسد!
طالت المقدمة، فسامحني أخي القارئ، ولكن جلال كشك بالنسبة لي أبي الروحي الذي لم أعرف مثله ولم أجد مثله حتى ظهر حازم أبو إسماعيل فملأ بعض ذلك الفراغ، لقد كان جلال كشك عقلية فذة تنطلق من معرفة غزيرة موسوعية متعدّدة المشارب والاهتمامات يعبر عنها لسان ناري يُذَكِّر بلسان ابن حزم رحمه الله. ولقد كان كذلك لأن الإسلاميين –لظروف كثيرة ليس هذا موضع بيانها- يندر فيهم من يفهم السياسة والإسلام معا، كما يندر فيهم الثوري على بصيرة وفطنة، ولقد كان جلال كشك هكذا: طاقة ثورية مع قراءة بصيرة للتاريخ مع اعتزاز كامل بثقافته الإسلامية مع يقظة تامة للأوضاع والأحوال السياسية، ولهذا كانت كتبه –حتى الصغير منها- وجبة فكرية وروحية دسمة.
صحيح أنه لا يمكن أن نصفه بالعالم في الشريعة لكنه كان عميقا في فهم النموذج الإسلامي وتميزه الحضاري عن النموذج الغربي وكان يضع يديه بكفاءة على نقاط الافتراق والتناقض. وصحيح أنه لا يمكن وصفه بالمؤرّخ بالميزان الأكاديمي إلا أن ما لديه من فهم لسنن التاريخ والجمع بين إدراك مساره العام والتقاط تفاصيله مع سعة الاطلاع في التواريخ يجعله في عداد عظماء المؤرّخين، بل وجدت في كلامه من روائع هذا الفهم ما لم أجده في معظم من تشربوا التاريخ أكاديميا.
كيف ينظر “جلال كشك” للدولة العثمانية
ونحن نستثمر حلول ذكراه، ونستثمر تخصص هذا الموقع في الشأن التركي، لنورد بعضا مما كتبه جلال كشك في شأن الدولة العثمانية والسياسة التركية.
(1)
ينادي جلال كشك على العرب بالحذر من المصادر التي يتلقّون عنها التاريخ العثماني، وذلك في كتابه المكتوب في منتصف الستينات، أي في ذروة طغيان القومية العربية، وحيث لا يُرى الأتراك إلا بعيون الكراهية والبغضاء، فيقول:
“حتى نحدّد العلاقة السليمة بين العروبة والإسلام، كان لابد للبحث أن يتناول بالتحليل تاريخ الدولة العثمانية، حيث كنا نحن العرب خلال القرون الأربعة الأخيرة، وحيث وصل التناقض إلى أقصاه لأول مرة في تاريخنا الإسلامي والعربي.
والدولة العثمانية كانت العدو الأول لأوروبا الصليبية في نهضتها، اصطدمت بها عند بداية توسّعها، وهدّدت الدولة العثمانية هذا التوسع وأوقفته، بل وغزت أوروبا في عقر دارها وحملت راية الإسلام إلى أسوار فيينا، وارتبطت بعداوة أبدية مع روسيا القيصرية، إذ كان التوسع القيصري الروسي يصطدم بها ويتم على حسابها، ثم كانت هي الفريسة التي تقاسمتها الدول الأوروبية وتنازعتها.
من هنا كان يجب على المفكرين المسلمين والعرب أن ينظروا بعين الشك لكل ما وصلهم من تفسير أو تحليل لتاريخ الدولة العثمانية.. لأن مصادره هي العدو.. العدو الذي نجح في رسم صورة مزرية لآخر ممثلي حضارة المسلمين. صورة كانت تهدف إلى تذكية حماسة شعوبه لمواجهتها ولتبرير سلوكه الإجرامي ضدّها وتآمره، بل تجاهره في تفتيتها وتمزيقها والتهامها عضوا عضوا وهي حية” .
(2)
ويمضى خطوة أخرى إلى الأمام فينادي بأن حديث الحق عن القومية العربية لابد أن يتذكّر فضل العثمانيين عليه، وألا يكون تابعا أعمى لحركات مسيحية كانت قد نبتت ضد الدولة العثمانية في الشام فاتخذت لافتة القومية العربية، يقول:
“قضية القومية العربية اللا إسلامية مرتبطة تمام الارتباط بقضية الدولة العثمانية؛ فهذه الحركات قد نبتت ضد الدولة العثمانية وفي الشام بالذات، وحجتها الوحيدة هي مقاومتها للسلطة التركية، ومن ثَم كان التقويم السليم للدولة العثمانية ضروريا لتحديد طبيعة هذه الحركات.
وإذا أردنا أن نخرج بحكم موضوعي على الدولة العثمانية فيجب أن نفتش عن الحقائق بعيدا عن كتابات الأوروبيين وآرائهم، فالدولة العثمانية كانت آخر حاجز إسلامي في وجه صليبية أوروبا.. إنها هي التي منعت الغزو الصليبي للعالم الإسلامي على الأقل من بوابته الأمامية طوال ثلاثة قرون. وهي التي حالت دون احتلال الوطن العربي أربعة قرون كاملة، فمنعت فناءه القومي.
الدولة العثمانية هي التي انتزعت القسطنطينية وأسمتها إسلام بول بعد أن صمدت القسطنطينية أمام الزحف الإسلامي قرابة تسعة قرون، فتركت الدولة العثمانية بفتحها جرحا داميا في كل صليبي أوروبي، لم يمحه إلا عودة الصلبان تطل من جديد في كنيسة آيا صوفيا بعد أربعة قرون تردّد الآذان من مآذنها.
والدولة العثمانية هي التي طرقت أبواب فيينا وقهرت شرق أوروبا حتى أصبح اسم “تركي” (وهو ما زال إلى عهدنا هذا يعني “مسلم” عند العامة في أوروبا) مصدر رعب يخيفون به الأطفال. فمن الوجهة الصليبية البحتة، أي بالتفسير الذي يرى في الصراع الديني أحد عوامل تكوين تاريخ العلاقات بين أوروبا والشرق.. بهذا التفسير نرى أنه من الطبيعي جدا أن تكون الدولة العثمانية هدفا لحملات تشهير غير علمية وغير منصفة تهدف إلى تلطيخ سمعة الإسلام وإثارة التعصّب الديني عند مقاتلي أوروبا للهجوم على البرابرة: الدولة العثمانية واستئصال الإسلام الشرير!
وهذه الهيستريا التشنجية هي التي حرّكت التضامن الأوروبي خلف كل انتفاضة مسيحية ضد الدولة العثمانية. فالحرب الصليبية التي بدأت في القرن الحادي عشر، ثم حملت لواءها البرتغال وإسبانيا.. لتعم بعد ذلك أوروبا، هذه الحروب الصليبية اصطدمت بموجة إسلامية جارفة، أنقذت الإسلام من أن تطويه الموجة المسيحية الزاحفة.
هذا اللقاء أو الصدام، أورث أوروبا الحقد والعداوة ضد الدولة العثمانية.
وإذا نحّينا هذا المنهاج في التفسير واستبعدنا الدافع الديني تماما لنكون “شُطّارً” من أبناء العصر “المتنورين” فسنرى أن الدولة العثمانية كانت منذ أواخر القرن الثامن عشر تمثل الفريسة المطروحة أمام الذئاب الاستعمارية للتقسيم والنهض والابتلاع.
كل التوسع الاستعماري كان يصطدم بها ويقتطع منها.. فرنسا في شمال إفريقيا وساحل الشام، إنجلترا في جنوب الجزيرة العربية والخليج.. ثم مصر وإفريقيا فالعراق.. إيطاليا في طرابلس.. روسيا على طول امتدادها وتوسعها سواء في الولايات الإسلامية التي لجأت إلى ضمّها أو في البلقان حيث جرى طرد المسلمين وإبادتهم.
كان من الطبيعي أن يبرّر هؤلاء الذئاب حرصهم على تحطيم الدولة العثمانية واقتطاع أجزائها. تبرير ذلك بدافع إنساني وتقدّمي.. لا بد أن تكون الفريسة رجعية وكريهة وغير جديرة بالبقاء حتى تغدو عملية غزوها إنسانية رحيمة، ومن أجل تقدم البشرية وتحرير الشعوب البائسة من النير التركي. رسالة الرجل الأبيض الذي حمَّلتْه الأقدار مسؤولية تحرير كل الجنس البشري. تحريره من كل عبودية إلا عبودية السيد الأبيض واستغلاله.
من هنا يجب أن نتحفظ عندما يقول جلادستون أن السلطان عبد الحميد هو الشيطان، لأن جلادستون هو “إبليس عينه”، فهو الذي قضى على استقلالنا.
لنرفض هذه الأحكام المسبقة والصورة الرهيبة التي تكتبها أقلام صليبية واستعمارية عن الدولة العثمانية فقد كانت هذه الدولة وما زالت هدفا ممتازا لعمليات الغزو الفكري.. ولنحاول أن نتفهّم ماذا كانت الدولة تمثل في التاريخ، وكيف قامت، ولماذا قامت، وكيف انهارت.
(3)
ثم يمضى خطوة أخرى للأمام في كتابه التالي الذي صدر في مطلع السبعينيات “حوار في أنقرة”، فدافع عن الدولة العثمانية ضد اتهامات الأتراك الأتاتوركية، فمن ذلك أنه سُئل: هل تنكر أن الدول العربية فقدت عروبتها بالفتح التركي؟
قال: “العكس هو الصحيح، البلاد التي فتحها العثمانيون هي التي بقيت عربية؛ إسبانيا، البرتغال، صقلية، رودس، كريت، مالطة، وشرق وغرب ووسط أفريقيا، كلها كانت عربية وفقدت عروبتها لأن السيوف التركية لم تحمها.. الاستعمار الغربي الذي ظهر مع قيام الدولة العثمانية كإمبراطورية كبرى كان يحمل طابع الإبادة القومية.. ولو امتد الغزو الغربي من إسبانيا والبرتغال إلى الشاطئ الإفريقي، ثم لو انتشر إلى الشاطئ السوري لما بقينا عربا حتى الآن.. بل لكُنّا شيئا شبيها بالمالطيين، أو حتى كسكان أمريكا اللاتينية في أفضل الأحوال. الذي أبقانا عربا هم الأتراك والمدفعية التركية والأسطول التركي والدم التركي الذي دافع عن شواطئنا ثلاثة قرون حتى نضجت عوامل المقاومة وتغير شكل الاستعمار الغربي، ولم يعد الاحتلال الغربي يحمل خطر الإبادة القومية التي كان يمثلها في القرن الخامس عشر أو السادس عشر” .
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس