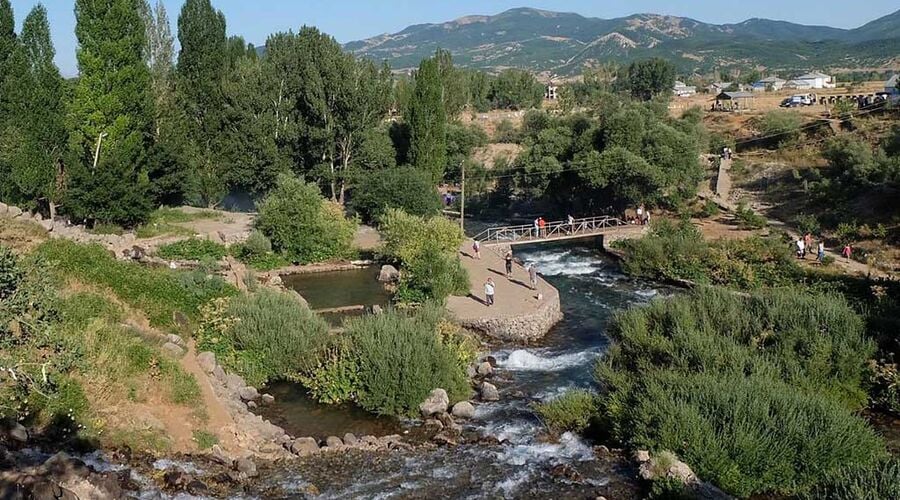
ترك برس
كان الكاهن سطيح يتلوّى جسده كالقماش في جلساته المؤلمة التي يُزعم أنه يتلبسه فيها الجن. وكأنه لا عظام في جسده. وكان يعبر عن نبوءاته في هذه الجلسات بأسلوب السجع غالبًا. السجع أدناه من أشهر نبوءات الكاهن سطيح، ويُروى أنه تنبأ بغزو الأحباش لليمن.
’رأيت حممة
خرجت من ظلمة
فوقعت بأرض تهمة
فأكلت منها كل ذات جمجمة‘
في الأيام الأخيرة، أصبح الأكراد محور الحديث بسبب حل منظمة حزب العمال الكردستاني. كما كانوا عليه في الخمسين سنة الماضية من تاريخ تركيا، والخمسين التي سبقتها…
لكن رغم تركيز الضوء عليهم، تستمر صورة الأكراد في أذهان المجتمع التركي في التشكل بعيدًا عن الواقع، أقرب إلى الخيال. هذه النظرة للأكراد كموضوع في عالم خيالي منفصل عن الحقيقة ليست حكرًا على الأتراك أو بقية مكونات المجتمع، فالأكراد أنفسهم ينظرون لأنفسهم من خلال عدسة خيالية بعيدة عن واقعهم. والأمر نفسه ينطبق على المجال الأكاديمي والإعلام والفن والبيروقراطية الحكومية. تشبه صورة الأكراد في أذهان كثيرين – بتعبير مقتبس من جن الكاهن سطيح – قطيعًا من قطاع الطرق القروسطية قفزوا من ظلام تاريخ غامض مرعب إلى شوارع المدينة المضيئة.
يمكن مناقشة كيفية تشكل هذه الصور طويلًا. لكن القول إن الأكراد حُفظوا – سواء في تنظيمهم المجتمعي أو ثقافة حياتهم اليومية أو حاجز اللغة الأهم – داخل قلعة منعزلة بعيدًا عن تحديث تركيا، ليس بعيدًا عن الحقيقة. ومن الواضح أن هذا كان موقفًا اتفقت عليه النخب الجمهورية والنخب السياسية الكردية على حد سواء. في مواجهة سياسات الاستيعاب القسري التي فرضتها الجمهورية، اتخذت النخب السياسية الكردية لوقت طويل من اللغة الكردية – المقدسة دينيًا أيضًا – ملاذًا. في مقابل التغريب القسري الذي فرضه الكماليون، اتبع زعماء الأكراد لزمن طويل ممارسة يمكن تلخيصها بـ “ابقَ كرديًا تبقَ مسلمًا”. أما في عالم حزب العمال الكردستاني، فقد استمرت هذه العزلة عبر “ضغوط الحارة” التي فرضها “العشيرة السياسية” القائمة على أيديولوجيا قومية متطرفة معادية للدين ومنفصلة عن الكردية. بالمثل، رأى النخب الحكومية أن بقاء الأكراد بعيدًا عن الأنظار كعنصر “شاذ” في مشروع الدولة القومية الناشئة ضرورة لنجاح هذا المشروع.
نتيجة لذلك، أصبح التصور السائد عن الأكراد – الذي شكّلته وسائل الإعلام والفن – مرتبطًا بعالم “مريب” من المفاهيم مثل الجريمة والتمرد والإرهاب والعنف والتخلف والدين والريفيّة والعشائرية والمحافظة. ولتكريس هذه الصورة، استُخدمت بفظاظة انتفاضتان كبيرتان في السنوات الأولى للجمهورية – انتفاضة الشيخ سعيد وتمرد درسيم – بالإضافة إلى الإرهاب الدامي الذي عشناه في الخمسين سنة الماضية. ورغم استنادها إلى حقائق مؤلمة، تبقى صورة الأكراد التي صنعتها هذه المفاهيم وحقنتها وسائل الإعلام والفن في المجتمع بعيدة عن الواقع وخيالية. وبكل صدمتها، فإن الخيال لا يعدو أن يكون تشويهًا للحقيقة. وليس من الضروري أن تكون كاهنا مثل سطيح لترى كيف استُخدمت هذه الحقيقة المشوهة – التي تمس المواطن العادي أيضًا – كـ”مسكّن كاذب” لمصالح كبيرة ومخاوف وهواجس لدى الدولة.
كما أنه ليس سرًا أن هذه الصور الخيالية المشوهة قدّمت شرعية لمجموعة من المخاوف والهواجس المصنفة تحت عنوان “التقسيم”، وللضغوط المبنية عليها، وكذلك لسلم من “المصالح” الخصبة في كل مجالات المجتمع من البيروقراطية إلى عالم الأعمال، ومن السياسة إلى الاقتصاد. بينما لا يعيش الأكراد ولا بقية أمتنا المسماة “الأمة التركية” في “حقيقة” تتطابق مع هذه الصور الخيالية. بل إن الحقيقة ظاهرة متعددة الأوجه لا تنتهي. القوة الديناميكية التحويلية للحياة تعيد تشكيل كل شيء – بما في ذلك الحقيقة نفسها – باستمرار. التجربة الفردية للتغيرات التي تحدث في عمر الإنسان كافية لإدراك استحالة وجود حقيقة ثابتة وجامدة.
فكرة قيام الدول على أساس عرقي شائعة في الغرب منذ أكثر من مئتي عام، لكنها فكرة حديثة نسبيًا لدينا. التجانس الديموغرافي كأحد الأعمدة الرئيسية للدولة يصبح ذا معنى فقط مع قدرة الدولة على السيطرة. في الغرب، كانت عملية تأسيس الدول القومية منظمة من قبل النبلاء والنخب كشكل من أشكال الاستثمار. في الواقع، معظم الدول القومية في الغرب تأسست عبر حروب استثمرت فيها هذه الفئات. وما يسمونه ديمقراطية ليس سوى سيطرة هؤلاء المستثمرين على الدولة كـ”شركاء”. وهكذا تحولت الحرب – التي كانت رياضة أرستقراطية – إلى واجب “المواطن” المكلف بالولاء للأمة مقابل حقوق المواطنة (حق التصويت، الأمن). هنا تصبح الدولة القومية – التي تمتلك قدرة السيطرة على كل الموارد المجتمعية وآلة ضغط بيروقراطية ضخمة تتعاظم تراكميًا وخطابًا أيديولوجيًا يشرعن عملية الضغط والتحكم – بحاجة ماسة إلى “الأمة” كتجانس عرقي. هذه “الأمم” – التي هي تقريبًا كلها “جماعات متخيلة” – تُختلق عبر سردية تاريخية وهي في الأساس مجال “استثماري”.
بينما الديموغرافيا – بمعناها البيولوجي – لا تقوم على العرق بقدر ما تقوم على الجغرافيا والتاريخ المتجذر في الكون الثقافي. هذه الجذور والرموز الثقافية الحيوية والمستمرة تُسمى في الكون الثقافي الإسلامي “مِلّة” ولا علاقة لها بالتركيبة العرقية. لذلك فإن البنية الاجتماعية التي شكلتها الجغرافيا والتاريخ في هذه الأرض، والدولة القائمة عليها، ليست دولة “استثمار” بالمعنى الغربي، بل دولة “قيمة” متجذرة في التاريخ والجغرافيا، دولة “كريمة”. ولهذا ربما ظلت الأيديولوجيات القومية السائدة في تركيا “خجولة” عمومًا في التأكيد على العرق والجذور العرقية. حتى الكمالية – الأيديولوجية المؤسسة للجمهورية – اضطرت لتعريف “التركي” بشكل غامض جدًا بـ”من يشعر بأنه تركي” بدلًا من التركيز على النسب والأصل. تعريف “التركية” لدى معظم الأوساط القومية يشبه الإيمان الديني الذي يمكن الدخول فيه والخروج منه.
لذلك يمكننا القول بثقة: تعريف الأمة – التي هي أحد الأعمدة الأساسية للدولة – ليس قائمًا على العرق بل على القيمة. في سنوات تأسيس الجمهورية، لم يكن القاسم المشترك الرئيسي لأمتنا هو البنى العرقية بل الدين الإسلامي. البنى العرقية واللغات والاختلافات الإقليمية هي ألوان طبيعية للأمة يجب الحفاظ عليها، حقوق فطرية. وبالتالي، حماية حقوق كل مكون عرقي ضمن “الأمة” شرط أساسي لكوننا أمة.
في هذا السياق، من الضروري التعامل مع الأكراد – الذين خضعوا لقمع واستيعاب قسري منذ سنوات تأسيس الجمهورية – من داخل واقعهم، لا من داخل العالم الخيالي المذكور في المقدمة. من الواضح أن انتهاء إرهاب حزب العمال الكردستاني بعد عقود سيخلق – بالإضافة إلى الارتياح والفرح الواضحين لدى الأكراد وبقية أمتنا – قدرًا كبيرًا من الحيرة. من الواضح أن إرهاب حزب العمال الكردستاني خلق منطقة “راحة” مزدوجة في السياسة التركية. قرار الحل الآن ينهي هذه “المنطقة المريحة”، ويُظهر هزات تكتونية في السياسة، وأنه لم يعد من السهل توحيد الطبقات الاجتماعية التي كانت تُسيطر عليها بسهولة عبر هذه الصور الخيالية المريحة.
سيواجه المجتمع الكردي أو من عاش في عالم حزب العمال الكردستاني حيرة الارتباك عند الخروج من عقلية “الضحية”. بالمثل، سيقع العديد من “الباعة” و”الصناعات” السياسية التي استفادت من الإرهاب في فراغ عميق. في الواقع، نلاحظ أن هذا التطور – الذي يقف وراءه مراكز القرار في جهاز الدولة و”أصحابها” الأيديولوجيون بإصرار كبير – بدأ يثير تذمرًا خافتًا في مختلف طبقات الدولة والسياسة ونخب الإعلام.
ما يثير هواجس خفية في خلفية حل منظمة إرهابية عتيقة انتهى عمرها هو في الحقيقة واقع الأكراد. المدن التي تحولت في ظلام تسعينيات القرن الماضي إلى ما يشبه “مخيمات لاجئين”، أصبحت الآن بشوارعها البراقة وأحيائها الواسعة المضيئة وسكانها المتحولين بشكل ملحوظ نحو الحداثة، تهز الصور النمطية في أذهان “الأكراد” و”الأتراك” على حد سواء. المجتمع الكردي – الذي يشهد ظهور طبقة وسطى ملحوظة، وتوسعًا حضريًا وصل إلى المعدل التركي، وتحولًا في بنية الأسر من 8-10 أطفال إلى أسر صغيرة بطفل أو اثنين كما هو المعدل الوطني – بدأ يظهر مع تبدد ضباب إرهاب حزب العمال الكردستاني.
هذا المجتمع – الذي لا يقل ولاءً للبلد والوطن وثقةً وتملكًا عن السكان المسماة “أتراك” – يواجهنا الآن بحاجته للتعبير عن نفسه، وقول حقائقه، والعيش بطبيعته. على الأرجح سيشعر الأكراد بالحيرة تجاه هذه الحقيقة أولًا.
بدلًا من مواجهة حقيقة الأكراد في تركيا والمنطقة، والسعي لجعلهم شركاء في الدولة، فإن موظفي الدولة المتقاعدين – الذين يشعرون كالإقطاعيين القروسطية الذين استثمروا في الحرب ليصبحوا شركاء في الدولة ولا يريدون شركاء بأي حال – ونخب الدولة المزعومة الذين يستفيدون منهم، تنبؤاتهم المشؤومة أصبحت تثير الإغماء. لأن الدولة في هذه الأرض ليست كما يتصورون، ولا هم مؤهلون لامتلاك الدولة.
بعد خمسين عامًا، لا يمكن مقارنة هؤلاء الذين يتنبؤون بظل منظمة إرهابية مفلسة بالكهنة المحترفين مثل سطيح، لكن ما يفعله هؤلاء المتقاعدون ليس سوى نبوءة.
هؤلاء الذين هم بعيدون جدًا عن الواقع لدرجة أنهم لا يرون كيف أن ديكتاتورية مقيتة بنيت على الأكاذيب والأوهام قد انهارت بفضل صبر الأمة ورفقها، هم في الواقع في نفس مكان متقاعدي حزب العمال الكردستاني الذين أرادوا تخويف الأمة. كلا الجانبين يعرف طريقًا واحدًا: بث الخوف.
لكن أمتنا محصنة ضد هذه الألاعيب. سواء كان حزب العمال الكردستاني الذي عذب الأمة خمسين عامًا بوضع “الحل السياسي والديمقراطية والسلام” في المقدمة، أو هؤلاء الذين يملؤون خدودهم ويحدقون بعيونهم ويصرخون “وطن، أمة” زيفًا، ما يمكن أن يقدموه لهذه الأمة ليس سوى الأذى.
**تقرير تحليلي للكاتب والسياسي التركي مصطفى إكيجي، نشرته مجلة كريتيك باكيش الفكرية
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!













