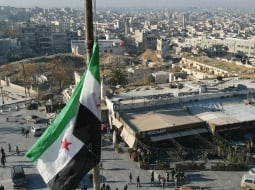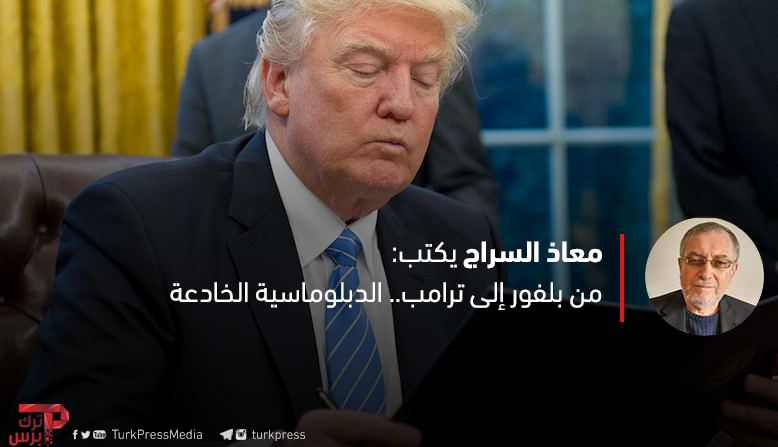
معاذ السراج - خاص ترك برس
ما حدث قبل أيام في الشمال السوري، أو ما سمّي بالمنطقة الآمنة، يلقي الضوء على طرف من واقع السياسة والدبلوماسية الدولية التي تضطلع بها الدول الكبرى، وتدير شؤون العالم من خلالها.
قلما صدقت مقولة إن السياسة تقود إلى السلام، معظم التجارب المعاصرة، بوجه خاص، تقود إلى هذا الاستنتاج، والواقع أنها كانت على الدوام، الوجه الآخر للحرب، تديرهما ما تسمى بالدبلوماسية، الواسطة الأكثر هدوءًا ومكرًا ودهاءً، وأحد أخطر موجهي دفة الصراعات... وعلى خلاف ما يوحي به المصطلح من الأناقة والبهاء والاستحضار الجميل، الذي تكاد تطالعنا فيه المحافل الدبلوماسية الجميلة كل صباح، فإن واقع الدبلوماسية لا يبدو في الواقع كذلك، كما يتكشف الأمر يوما بعد يوم.
الرئيس الأمريكي ترامب، وخلال الأيام القليلة الفائتة، قلب الطاولة على رؤوس حلفائه من الميليشيات الانفصالية شمال سورية، وبصورة مفاجئة وشديدة الوطأة والقسوة، مخلفًا الكثير من مشاعر الحزن والغضب والإحباط. وكانت المقايضات والشتائم أحيانًا بعضًا من مفرداته كما جرت عادته.
ولم تكن المرة الأولى، فقد سبقت الفعلة نفسها، قبل سنتين في مدينة كركوك العراقية، التي خرجت في ساعات فقط، عن هيمنة تنظيم "ي ب ك"، بعد أن ساد الاعتقاد بأنها انضمت نهائيًا إلى إقليم شمال العراق، الذي مرّ على تأسيسه ما يقرب من ثلاثة عقود، برعاية أمريكا وأوربا، وربما كان الإقليم هو الآخر تحت خطر الاجتياح، لولا التوازنات والضغوط الدولية.
لكن الحقيقة أن الأكراد لم يكونوا وحدهم من وقعوا في مثل هذه المطبات، فالسوريون في ثورتهم كانوا كذلك من ضحاياها، بشتى أطيافهم وزعاماتهم، وغيرهم كثير، والتاريخ القريب، وحتى البعيد منه، يتحفنا بأمثلة ونماذج لا تكاد تنتهي.
العرب، وزعيمهم الشريف حسين، في ثورتهم الكبرى، قبل مائة عام، وقعوا ضحية أسلوب المكر والتلاعب بالأصدقاء والحلفاء، ولم تسعفهم نواياهم الحسنة، التي لم تكن في الواقع سوى سذاجة وبساطة أوقعتهم في مصير بائس كان أشد عليهم من الحروب نفسها. وفي الوقت الذي كانت تراود الشريف ومن حوله فكرة إنشاء الدولة العربية الكبرى، كانت الأوساط الدبلوماسية البريطانية والغربية تتداول ما مفاده "استحالة دولة مستقلة تضم كل الأراضي العربية وأن إنشاء مثل هذه الدولة لا يمكن أن يكون في الوقت الحاضر إلا حلمًا". أما الكولونيل لورانس، الصديق الصدوق، والحليف الموثوق، فكان لا يفتأ يكرر في مجالسه قائلًا: "وقد حاولت غير مرة أن أقول له (الأمير عبد الله بن الحسين) إن هذا الشيخ الساذج لم يحصل منا على وعد صريح أو غير صريح من أي نوع، وأن سفينتهم قد تغرق بسبب سياسته الخرقاء. ولكني – لو فعلت – لكنت بذلك قد خنت رؤسائي الإنكليز".
وأيًا ما كان، فإن ما اعتبره الشريف حسين والعرب خيانة بريطانيا لهم كانت في النهاية النقطة المحورية في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، والأساس الذي تقوم عليه اليوم كل المشكلات والقضايا الكبرى...
بالأسلوب ذاته تم التعامل مع وعود الساسة البريطانيين، واليهود، فيما يتعلق بتنفيذ وعد بلفور، وهذه المرة، بمشاركة الكثير من النخب والزعامات العربية، وإن اختلفت الذرائع والمسوغات.
ولم يكن سرًا، أن عددًا من الوطنيين السوريين قد مارسوا ضغطًا في سنتي 1921 و1922 على القادة الفلسطينيين بهدف التوصل إلى تسوية مع الصهيونيين، كما يقول فيليب خوري وغيره، وطالما تعددت، وعلى انفراد، لقاءاتهم "بقادة صهاينة في لندن وفي فلسطين، للتحادث معهم بشأن إمكانات التوصل إلى حل مشترك".
لاحقًا، وفي ثورة 1936 في فلسطين، اشتكى العقيد غيلبيرت ماكيريث، القنصل البريطاني في دمشق، في مذكرة لرؤساءه في لندن: "إنه لواقع لافت أن السلطات البريطانية في فلسطين، وبصورة أخص في شرق الأردن، أظهرت تجاه قطاع طرق وثوار سوريين ترحيبًا، علينا الآن أن نأسف له بصورة محزنة. والشوكة الحادة في خاصرتنا اليوم هي محمد الأشمر، رئيس عصابة..."، فتلقى الإجابة من جميل مردم بك، رئيس الوزراء السوري حينذاك: "البريطانيون يستطيعون الاعتماد على تعاون الحكومة تعاونًا فعالًا في أن تخمد، ضمن حدود الجمهورية السورية، أي نشاط أو تخطيط معاد للإرادة البريطانية في فلسطين".
وبعد استئناف الثورة في فلسطين أعلن جميل مردم أنه يستنكر "الإرهاب" الجاري في فلسطين، مضيفًا، أن الحكومة السورية وبالتشاور مع السلطات البريطانية والفرنسية، "كانت تتخذ جميع الخطوات لمنع تهريب الأسلحة والثوار إلى فلسطين".
مصطلحات "سورية أولًا"، و"الإرهاب" تداولتها الدبلوماسية منذ ذلك الوقت.
أعضاء في الوكالة اليهودية قاموا بزيارات متعددة لقادة سوريين وعرب آخرين في باريس ودمشق للوقوف على مشكلة العلاقات العربية – اليهودية، وللاطلاع أكثر على القوى والتطورات في البلاد العربية. وكان من بين هؤلاء حاييم وايزمن وديفيد بن غوريون وموشي شرتوك (شاريت)، وإلياهو إبشتاين (إيلات). وكان بين القادة الذين زارهم أعضاء الوكالة بعض من اعضاء الكتلة الوطنية، ومنهم: جميل مردم وشكري القوتلي وفخري البارودي ونسيب البكري وفايز الخوري ولطفي الحفار.
ما درجت عليه جميع الأنظمة في سورية، بوجه خاص، من شرعنة نفسها بمصطلحات العروبة، وقضية فلسطين، وفاقت فيها سائر الدول العربية، قديمة جديدة، انتهى عاجلًا أو آجلًا إلى تناقض حرج بين الأيديولوجية العربية ومصالح سورية وفلسطين والعرب عامة، وقاد إلى نتائج كارثية سيستمر حصاد هشيمها طويلًا.
سبق لشكيب أرسلان، وكان على مقربة من الأحداث وصانعيها، عاصر الحرب الأولى، وسايكس بيكو، وصف أساليب الدبلوماسية البريطانية بقوله: "قيل إن في نظارة الخارجية الإنكليزية دائرة خاصة يُحال إليها تحرير المعاهدات والبيانات الرسمية التي تتعمد فيها إنكلترا الكذب والنكث وخداع دولة تريد أن تسكِّنها مؤقتًا إلى أن يُتاح لها الغدر بها، أو خطاب شعب تغلب عليه السذاجة، فترى إنكلترا وجوب الضحك من ذقون أبنائه إلخ...". ونقل أرسلان عن السنيور جيوليتي (رئيس وزراء إيطالي سابق) قوله: "إنهم كذبوا علينا كما كذبوا على العرب"، وروى عن بسمارك أنه قال: "كيف يمكن أن أتفق معها – أي إنكلترا - وهي لا تدخل تحت عهد إن لم يكن قابلًا لعدة تأويلات".
وإذا كانت بريطانيا، فيما سلف، في مقعد (صندوق العربة)، كما يقول ألبرت حوراني، حينما كانت تمسك بكل المناطق المحتلة من الشرق الأدنى، وتحتفظ على الدوام، بمواقفها في كل مكان بالتحالف مع أصحاب المصالح الثابتة، حتى "صارت تعتبر عائقًا في طريق التغيير المفيد. فلقد بلغت الحد الأقصى في خصلة المرونة الانتهازية التي يعتبرها عدد من الإنكليز مزية في سياستهم، رغم أنها في الحقيقة ضعف شديد...". ومع أن الصورة قد تغيرت اليوم، إلى حد كبير، ودخل على الخط شركاء آخرون، لكن اللعبة الدبلوماسية لم تزل كما هي، "خداع" و"تغرير" و"تلاعب" حتى بالحلفاء والأصدقاء، ولا يبدو أنها في طريقها إلى التغيير.
"تحت القبعات الرسمية، ودخان الدبلوماسيين ورجال الدولة"، كما يقول جيرمي سولت، "كان الأوربيون منقسمين في طموحاتهم بما يجمع بينهم كلهم: النفاق والطمع والشكوك، والمصالح الشخصية والتحامل المسبق... وبيانات البلاغة الرفيعة لا يعادلها إلا الحقائق الوضيعة".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس