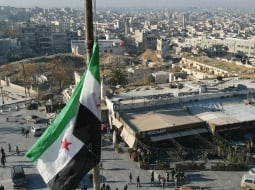جانين ريتش - أوبن ديموكراسي - ترجمة وتحرير ترك برس
عندما أكتب هذا المقال يكون قد مضى خمسة أشهر على محاولة الانقلاب التي أخفقت في تحقيق هدفها في الإطاحة بالرئيس، رجب طيب أردوغان، والحكومة التركية عموما. في الأشهر الماضية تغيرت أشياء كثيرة.
بعض التغييرات واضحة مثل إعلان حالة الطوارئ التي لا يبدو أن لها موعد نهائي معين، وسجن منفذي الانقلاب وإدانة الشعب ووسائل الإعلام لهم بشدة، وفصل عدد كبير من الأكاديميين، وتقييد سفرهم إلى الخارج.
بعض هذه التغييرات أكثر حنكة، وتزحف بهدوء إلى نسيج الحياة اليومية: إطلاق حملة قوية شملت تغيير اسم جسر البوسفور إلى جسر شهداء 15 يوليو/ تموز. وهناك معرض للتصوير الفوتوغرافي يبرز في محطة مترو تقسيم المزدحمة، ويصور المدنيين وهم يقاتلون الجيش في ليلة الانقلاب. يقع المعرض في المكان الذي كان مخصصا لصور تاريخية لإسطنبول في الأيام الأولى للجمهورية، وهو اختيار ذو معزى.
وأخيرا وبعد فترة هدوء غريبة انفجرت قنبلتان استهدفتا سيارة للشرطة في أكبر شوارع بشيكتاش، أحد أشهر أحياء إسطنبول المعروف بحياة الليل.
يمثل مقطع الفيديو الذي ظهر في غضون ساعة من الهجوم ملخصا غريبا ومتقنا لإسطنبول اليوم: شابان يجلسان بالقرب من الشاطئ ليلا، يعزفان على الجيتار ويغنيان، بينما يسجل صديق ثالث غناءهما بهاتفه المحمول. وفي الخلفية وعبر الجانب الآخر للماء كانت المسافة قريبة لنشعر بحدوث انفجار ضخم.
وحيث إنني أقيم في إسطنبول، وبصفتي كاتبة فقد جعلتني هذه الأحداث أشعر بنوع من العجز وسوء الطالع، فمن جانب لست مواطنة تركية، ولا أريد أن أستخدم منصتي هنا في إسكات أو تشويه سمعة من يعرفون ويفهمون أكثر مني، والذين يقولون بالفعل ما يجب أن يقال بطرق أفضل مما أستطيع أنا أن أقوله.
ومع هذا فإن الكتابة تستمر بشعور أكبر من الكآبة. لقد كتب الكثير على الصعيد العالمي حول تركيا في الأيام والأشهر التي تلت الانقلاب، وكالعادة فإن الأصوات المحلية الواعية المطلعة لا يمكن سماعها وسط ضجيج التحليل الخارجي.
هناك اتجاه واضح في هذه المقالات التي حظيت بمعظم المصداقية في وسائل الإعلام الدولية-سواء أكانت مقالات تحليلية أو شخصية- إلى ادعاء أن تركيا تسير في طريق مظلم لا عودة منه، أو الادعاء على نحو قاطع أن تركيا قد انتهت، وأن مستقبلها قد قُيّد، وصار جزءا من مستقبل "دول العالم الثالث" التي نحب أن نبدي عدم رضانا عنها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتجاه ليس مقصورا على وسائل الإعلام الكبرى، مثل سي إن إن، وفوكس نيوز، فقد كان هناك عدد هائل من التحليلات ومقالات الرأي المماثلة التي نشرها مقيمون حاليون وسابقون في تركيا، أو أناس أمضوا فترة وجيزة في تركيا، أو نشرها آخرون لأسباب مختلفة ويشعرون بالارتباط العاطفي والشخصي بالمنطقة. النغمة السائدة في هذه المقالات نغمة قاتمة، تبرئ الماضي بوصفه وقت الفرح المفقود، أما المستقبل فهو غير موجود.
ويبدو في الواقع أن القليل جدا قد كتب في هذه المطاعن من توقعات انهيار تركيا. وعلى ذلك أوجه تذكيرا لطيفا إلى الصحفيين المحليين والدوليين والمحللين والباحثين والكتاب ومستخدمي تويتر: تركيا ليست ملكا لكم لكي تحكموا عليها بالموت، ولا يهم من أنتم أو ما مقدار معرفتكم بسياسة البلد أو المنطقة وثقافتها. تركيا لا تدين لكم بذلك حتى تشكل نفسها وفقا لما تعتقدون أنها ينبغي أن تكون، وعندما لا تفعل ذلك، فإن هذا لا يعني أن الدولة بعيدة عن الإنقاذ.
هذه الظاهرة بطبيعة الحال ليست مميزة لوسائل الإعلام التي تغطي أخبار تركيا، فقد استخدمت العناوين الرئيسة المبالغة في التشاؤم والكآبة وغياب المستقبل لإدانة كل بلد غير غربي تقريبا في مرحلة ما. لماذا يبدو من المستحيل النظر بنفس المستوى من الفهم والوضوح اللذين ننظر بهما إلى مجتمعاتنا وأن نوسع هذه النظرة لتشمل مجتمعات الآخرين؟
لا يوجد شيء من قبيل المكان الذي ضاع حقا والميؤوس منه حقا. إن الحقيقة بالغة الوضوح بحيث يبدو التكرار سخيفا، فجميع الأماكن وجميع الكيانات السياسية معقدة ومتعددة الطبقات. ما الغرض إذن من هذه المقالات التي تحمل عناوين مثل "إسطنبول طالها الخراب" إلا أن تكون ترويجا ذاتيا مدفوع الثمن للكاتب؟
هناك شيء من التوجه نحو "السباق إلى القاع" بين الكتاب والمحللين السياسيين الذين يدرسون المنطقة، وفي هذا السباق ترتبط هيبة المرء وحكمته المفترضة طرديا بمستوى سخريته من مستقبل الشرق الأوسط.
لا أقترح أن تكون التوقعات المشرقة الوردية البديل الأكثر مصداقية، فالأمور ليست واعدة في هذا الوقت. ومع ذلك لا يمكن تجاهل أن المقالات التي تتوقع مستويات أكبر من العنف والبؤس تحظى باهتمام أكبر، وأن الذين يتحدثون بهستريا صاخبة عن أن كل شيء كارثي هم أكثر تشويقا وذكاء.
إن إلقاء اللوم على تويتر أو على محطات نشرات الأخبار على مدار الساعة أو إلقاء اللوم على شيء يذاع على الهواء قد جعلنا غير متسامحين مع وجود فارق طفيف، وأن نكون غير قادرين على نحو متزايد عن التعامل مع الحقائق والدعاوى المحيطة بنا، ومن ثم تجعلنا حريصين على تصديق أي قصة أكثر ظلامية.
إن كانت تركيا قد انتهت حقا، وإذا دمرت إسطنبول وسقطت في حيل العنف المفترض في الشرق الأوسط، فما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إلى الملايين الذين ما يزالون يعيشون هنا؟ ألا تنكر هذه المقالات وجود النشطاء والباحثين وأصحاب المحال التجارية ومديري الحدائق والآباء ومن يقاتلون الظلم الموجود على مستويات متعددة في مجتمعاتهم (على الرغم من أن الظلم ليس أمرا خاصا بتلك المجتمعات).
أليس من المجحف عدم الإشارة إلى هؤلاء الناس على الإطلاق، وبدلا من الحديث عنهم تقدم إحصائيات للفقر وتدهور الأوضاع الحدودية والأعمال الإرهابية، كما لو كانت هناك معادلة رياضية لكيفية الإعلان عن مكان بأنه غير قابل للإنقاذ؟
ثمة فكرة عامة كاذبة تقول بأن الصحفيين والكتاب والمحللين هم مجرد مراقبين محايدين خارج نطاق التورط. إن كانت هناك أي ميزة لهذا الادعاء من قبل، فقد دمرها الإنترنت. الإخبار عن العنف هو أن تصير جزءا منه، وأن تخلق خطابا حوله له القدرة على الإقناع وإيجاد إحساس بأن ما يحدث أمر طبيعي.
لكن هذا بطبيعة الحال ليس اقتراحا بأن تكون الإجابة ببساطة هي عدم الإخبار عن أي شيء، بل يعني أن من الضروري فهم القوة المصاحبة للصوت الموثوق للمعلومات، واتخاذ خطوات لتجنب تطبيع العنف، وتجنب التبسيط المفرط للحالات المعقدة.
إن أنواع الصفات التي ترافق عموما المقالات المنشورة عن الشرق الأوسط (التي مزقتها الحرب، والمدمرة، والقديمة، والمتطرفة، والتاريخية) ترسم صورا في أذهان القراء لها قدرة تأثير كبيرة، فهي تخلق محورا للمعلومات وتشوه الواقع وتضيقه. إن قراءة هذا النوع من تقارير "يوم القيامة" بوصفها حقيقة مطلقة هي أكثر من مجرد أزمة سوء فهم.
لو أن مدينة مثل إسطنبول قد دمرت أو انتهت، فلماذا ينبغي لأي شخص أن يهتم بمستقبلها؟ يمكننا أن نحزن من أجلها، وربما نكتب بعض المنشورات العاطفية عنها على الفيسبوك لنظهر اهتمامنا بأحوال العالم، ثم ننسى.
وأخيرا لماذا يحاول بعضهم أن يسمع أصواتا من داخل مدينة لم تعد موجودة؟
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مواضيع أخرى للكاتب
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس