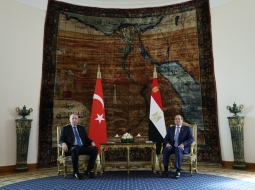ترك برس
استعرض الكاتب والإعلامي حسين عبد العزيز تحليلًا حول إمكانية إقامة مناطق آمنة في سوريا - التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - والنتائج التي قد تترتب على هذه الخطوة في حال طبقت.
وفي مقال له بموقع الجزيرة نت، أشار عبد العزيز إلى أن المعوق الأبرز الذي يُطرح مع إقامة المنطقة الآمنة هو حظر الطيران الجوي.
وأضاف: "مع أن المفهومين منفصلان نظريا، إلا أنهما على أرض الواقع متداخلان حسب ما بينت التجارب التاريخية في العراق والبوسنة والهرسك وليبيا، إذ لا إمكانية لإقامة مثل هذه المنطقة دون حظر للطيران وقوات برية تحميها، خصوصا في سوريا حيث فرقاء السلاح كثر، الأمر الذي يتطلب تجهيزات عسكرية هامة، كقواعد عسكرية قريبة قادرة على حماية المنطقة الآمنة، وفقًا للكاتب.
وفي ضوء ذلك، لن يكون أمام واشنطن سوى الشمال السوري بشقيه الغربي والشرقي (منطقة درع الفرات، منطقة قسد)، حيث توجد قاعدة إنجرليك في تركيا وقاعدتان صغيرتان للولايات المتحدة في الشمال الشرقي لسوريا في المناطق الكردية".
وأوضح الكاتب أنه "إذا كانت إدارة ترمب يمكن أن تلتف على مسألة القوات البرية بالاعتماد على القوى الموجودة على الأرض (درع الفرات، قسد) مع دعم لوجستي منها، إلا أن مسألة حظر الطيران هي الأصعب، من حيث إن الولايات المتحدة قد تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الطيران الروسي وطيران النظام، وهذا أمر سيعقد الوضع، وربما يدفعها للانخراط أكثر في الغابة السورية، وهو ما حاولت إدارة أوباما تلافيه".
المشكلة الأخرى - بحسب عبد العزيز - تكمن في اختيار المنطقة الآمنة، هل ستكتفي إدارة ترمب بمنطقة واحدة في الشمال السوري أم بمنطقتين؟
هنا تبرز التناقضات التركية الكردية وتأثيراتها على الخطة الأميركية الجديدة، ترفض أنقرة إقامة هذه المنطقة في الأراضي الخاضعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في الشمال الشرقي، لأن مثل هذه المنطقة ستحول الأرض إلى منطقة خارج النزاع، وبالتالي تصبح منطقة مغلقة للهيمنة الكردية.
وهذا يعني في القاموس العسكري التركي، استحالة ضرب الأكراد، صحيح أن المنطقة الشرقية من الشمال السوري بعيدة عن المعارك بين الأكراد وتركيا، لكن الحكومة التركية كانت وما تزال تتحين الفرصة لإضعاف الوجود الكردي في عموم الشمال السوري.
وتابع المقال… قد تتلاقى هنا الرؤية الكردية مع الرؤية التركية، فالأكراد لا يفضلون أيضا إقامة منطقة آمنة في مناطق سيطرتهم، خشية من تغير الميزان الديمغرافي بشكل حاد، ويصبح العرب أكثرية مطلقة، الأمر الذي يضعف قبضت الأكراد.
وفضلا عن ذلك، لا يثق الأكراد بتركيا، التي قد تستغل هذا الثقل العربي لإنشاء طابور خامس يقض مضجعهم.
لا يعني ذلك أن تركيا راضية كثيرا عن إقامة المنطقة الآمنة على أراض سيطرة "درع الفرات"، (من جرابلس أعالي نهر الفرات إلى تل رفعت غربا ونحو الريف الشمال لمدينة الباب جنوبا)، لكنها قد تكون مضطرة إلى ذلك للحيلولة دون إقامتها في المناطق الكردية.
قد تستفيد تركيا من تخفيف ضغط اللاجئين على أراضيها، وتستفيد ثانيا من تعزيز الثقل العربي والسني في منطقة سيطرتها داخل سوريا، وهو ثقل تبدو أنقرة بحاجة له ليكون سدا أمام الأكراد، في حال حصلت تغيرات مفاجئة في سوريا قد تقتضي خروج الأتراك من الشمال السوري، وربما تستفيد ثالثا في المستقبل من تحويل هذه الأرض إلى مقر للحكومة الانتقالية، لكن أنقرة تعي بالمقابل أن تحويل منطقة "درع الفرات" إلى منطقة آمنة سينهي مرحلة توسعها في الشمال، لأن هذه الأراض لن تتحول بعد ذلك إلى قاعدة عسكرية يمكن الانطلاق منها في حال أنشئت المنطقة الآمنة.
وبعيدا عن الشمال السوري، تتجه الأنظار نحو الجنوب على الحدود الأردنية حيث يمكن إقامة منطقة آمنة في ظل الهدوء العسكري، غير أن المشكلة التي تواجه هذه المنطقة في الجنوب تتمثل بكثرة الفاعلين العسكريين (إيران، حزب الله، النظام، تنظيم الدولة الإسلامية، فصائل المعارضة) من جهة، وغياب التموضع العسكري الجغرافي الثابت كما هو الحال في الشمال من جهة ثانية.
تعني إقامة منطقة آمنة في الجنوب السوري قيام الأردن مدعوما من الولايات المتحدة بإجراء طوق عسكري جغرافي.
لا يفضل الأردن الانخراط العسكري في سوريا، ولا يفضل بالمقابل بقاء اللاجئين في أراضيه بسبب التبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك، ناهيك عن الاعتبارات الأمنية.
يفضل الأردن إنشاء منطقة آمنة في الجنوب السوري لا تكون تحت حمايته مباشرة، وإنما تحت سيطرة "الجبهة الجنوبية" على الأرض، وحماية جوية أميركية، مع دعم أردني لوجستي، وهذا أمر قد يعقد عملية إقامة هذه المنطقة في الجنوب لعدم قدرة "الجبهة الجنوبية" على تأمينها، ولعدم رغبة الولايات المتحدة إرسال قوات لها إلى هذه المنطقة المفتقدة للحماية الكاملة كما هو الأمر في الشمال السوري في المنطقتين الكردية والتركية.
ليس المقصود أميركيا إنشاء مناطق آمنة أو عازلة بالمعنى العسكري، فمثل هذه المناطق قد تجاوزتها الأحداث العسكرية على الأرض نتيجة التفاهم الروسي التركي، والمشهد الميداني الجديد في الشمال السوري وطبيعة التحالفات الإقليمية الدولية لم تعد تسمحا بمثل هذا الفهم العسكري للمناطق الآمنة.
وحتى تركيا ذاتها التي طالبت خلال السنوات الماضية بإقامة منطقة آمنة ذات صبغة إنسانية وعسكرية في الوقت نفسه، لم تعد تطالب بها بعدما توجهت شرقا نحو الكرملين وحصلت على حصة جغرافية مهمة تحقق من خلالها جزءا من حل أزمة اللاجئين من جهة، وإنهاء التواصل الجغرافي للأكراد من جهة ثانية.
لن تخاطر أنقرة بطبيعة الحال بالمضي قدما في المشروع الأميركي وإن رحبت به من حيث المبدأ إلا بما يتماهى مع الأغراض الروسية، فلن تخسر تركيا ما حققته على الأرض السورية من نتائج بالغة الأهمية، وهي نتائج تم تحقيقها من البوابة الروسية وليس من البوابة الأميركية.
المشكلة هي أن ثمة خط رفيع بين منطقة آمنة لأغراض إنسانية ومنطقة آمنة لأغراض عسكرية، ذلك أن كلا المنطقتين تعنيان تحييد أرض جغرافية ما عن النزاع، وهذا أمر يتطلب موارد كبيرة لضمانها، بما فيها حظر الطيران الجوي.
ولذلك بدت موسكو ممتعضة من إعلان ترمب دون التشاور معها، فهي ترفض تحييد أي بقعة جغرافية عن الصراع قبيل اكتمال المشهد العسكري في عموم سوريا، وهو المشهد الذي عملت بجد على رسمه وتحديده.
المنطقة الآمنة لأغراض إنسانية من وجهة نظر موسكو، يمكن أن تتحول بقرار إلى منطقة عسكرية، وهذا يشكل ضربة قوية وقاصمة للمجهود الذي قامت به خلال العامين الماضيين، كما أن من شأن هذه المنطقة أن تعيد صياغة التحالفات من جديد، وتكون بمثابة أسفين بين تركيا وروسيا.
وربما يأتي تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في إطار الغمز السياسي، حين قال إن "الإدارة الأميركية الجديدة تطرح هذه الفكرة بصيغة تختلف عن الأفكار التي سبق أن طُرحت في المراحل الماضية للأزمة السورية، وأعني هنا الأفكار الخاصة بإنشاء منصة معينة في الأراضي السورية لإنشاء حكومة بديلة واستخدامها كمنصة انطلاق لإسقاط الحكومة".
تقبل موسكو بإقامة مناطق آمنة لأغراض إنسانية، لكنها تطالب أن يتم ذلك بالتنسيق معها ومع الأتراك وبموافقة النظام السوري لضمان تحييد هذه المنطقة عن النزاع بشكل نهائي.
ويفضل صناع القرار في الكرملين إقامة هذه المنطقة في المناطق التي تسيطر عليها تركيا لعدم ثقتهم بالأكراد المنخرطين كثيرا في البرنامج الأميركي من جهة، ولوضع حد للطموحات التركية في سوريا في حال تغيرت الظروف العسكرية السياسية من جهة ثانية.
بغض النظر عن الأسباب الإنسانية والسياسية التي تقف وراء توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإقامة مناطق آمنة في سوريا، فإن قراره يشكل تغيرا ملحوظا في التعاطي الأميركي حيال الأزمة السورية.
لكن المشكلة أن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة حيال سوريا ما تزال غامضة، ولا يعرف المدى الذي يمكن أن تتدخل في الولايات المتحدة، لأن مثل هذه المناطق تتطلب تدخلا أميركا من نوع ما.
مثل هذه المنطقة، وفي ظل استمرار المعارك المحيطة بها، وغياب الثقة بين الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة على الأرض، قد تدفع واشنطن دون وعي منها إلى الانخراط شيئا فشيئا في لعبة التوازنات الطائفية والعرقية، الأمر الذي قد يسبب لها توترات مع كثير من الأطراف بمن فيها بعض حلفائها.
وقد يستغل المحور الروسي الإيراني السوري تأزيم المناطق الآمنة من خلال عمليات تهجير شبه قسرية نحوها في حال لم تستجب إدارة ترمب لمطالب الروس.
وفي ظل أجواء طيران معقدة ومتشابكة، قد تجد واشنطن نفسها مضطرة إلى مواجهة الطيران السوري، فهي لن تسمح بتكرار تجربة البوسنة والهرسك عام 1992 حيث انتهكت القوات الصربية آنذاك حظر الطيران مئات المرات.
في ضوء ذلك يبدو أن الإدارة الأميركية لا تستطيع إقامة المناطق الآمنة من دون التعاون مع تركيا والأردن وروسيا ودول الخليج، وقد يعني ذلك دفع فواتير سياسية لبعض هذه الدول، الأمر الذي قد يعيد رسم وترتيب المشهد السوري من جديد، وهو مشهد ليس بالضرورة أن يأتي على حساب روسيا، وإنما على الأقل لن يجعلها وحدها اللاعب الأبرز في هذا المشهد.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!